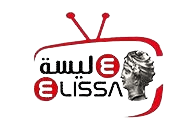56
.jpg)
.jpg)
مقال
تنشره غدا الإٍربعاء الموافق لـ 22 مارس 2017 إحدى الصحف العربيّة يتضمّن قراءة للأكاديمي الجامعي والكاتب التونسي
حسونة المصباحي للمشهد الثقافي التونسي خلال الحقبة الرومانيّة، قراءة غزيرة
المحتوى، عميقة الدلالات، يمكن تناولها كما يلي:
تنشره غدا الإٍربعاء الموافق لـ 22 مارس 2017 إحدى الصحف العربيّة يتضمّن قراءة للأكاديمي الجامعي والكاتب التونسي
حسونة المصباحي للمشهد الثقافي التونسي خلال الحقبة الرومانيّة، قراءة غزيرة
المحتوى، عميقة الدلالات، يمكن تناولها كما يلي:
يقول المصباحي: “كثيرة هي الكتب التي ألّفت عن أحوال البلاد التونسية في زمن الرومان
سواء قبل المسيح أو بعده، إلاّ أن أغلب هذه الكتب ظلّت محبوسة في دوائر ضيقة لأن
أغلبها كتب باللغة الفرنسية، وهذا ما ساهم في بقاء الإرث الروماني بتونس مسألة
غامضة للكثير من القراء التونسيين والعرب”.
سواء قبل المسيح أو بعده، إلاّ أن أغلب هذه الكتب ظلّت محبوسة في دوائر ضيقة لأن
أغلبها كتب باللغة الفرنسية، وهذا ما ساهم في بقاء الإرث الروماني بتونس مسألة
غامضة للكثير من القراء التونسيين والعرب”.
ويضيف: “كتاب “البلاد
التونسية في العهد الروماني” للمؤرخ التونسي عمّار المحجوبي جاء ليملأ فراغا
كبيرا، ويسمح لمن لا يحذقون لغة موليير، التي كتب بها هذا النمط من المؤلفات،
بالتعرف على الجوانب الحضارية والثقافية والسياسية والاجتماعية والعمرانية في
البلاد التونسية في العهد الروماني. كما أنه جاء ليثري جدلا حول التاريخ التونسي
الذي يرغب الأصوليون في تقزيمه، وتفتيته، وتشويهه ليكون عاكسا لرؤيتهم الضيقة،
ولتزمّتهم، وانغلاقهم”.
التونسية في العهد الروماني” للمؤرخ التونسي عمّار المحجوبي جاء ليملأ فراغا
كبيرا، ويسمح لمن لا يحذقون لغة موليير، التي كتب بها هذا النمط من المؤلفات،
بالتعرف على الجوانب الحضارية والثقافية والسياسية والاجتماعية والعمرانية في
البلاد التونسية في العهد الروماني. كما أنه جاء ليثري جدلا حول التاريخ التونسي
الذي يرغب الأصوليون في تقزيمه، وتفتيته، وتشويهه ليكون عاكسا لرؤيتهم الضيقة،
ولتزمّتهم، وانغلاقهم”.
في مقدمة الكتاب، الصادر عن دار تبر
الزمان بتونس، يشير عمّار المحجوبي إلى أن كتابه فرضته الفترة التي تعيشها تونس
راهنا، والتي تميزت خاصة بـ”إقرارها بميزة المواطن، وذاتيّة الفرد”، كما أنها
“فكّت عقدة قيده من التبعيّة، عشائريّة كانت أم طائفيّة أم عقائديّة”.
الزمان بتونس، يشير عمّار المحجوبي إلى أن كتابه فرضته الفترة التي تعيشها تونس
راهنا، والتي تميزت خاصة بـ”إقرارها بميزة المواطن، وذاتيّة الفرد”، كما أنها
“فكّت عقدة قيده من التبعيّة، عشائريّة كانت أم طائفيّة أم عقائديّة”.
وشخصيا شدني كثيرا الفصل البديع الذي خصصه المحجوبي للإشعاع الثقافي والحضاري
الذي تميزت به البلاد التونسية في العهد الروماني. وقبل قدوم الرومان كان أهل
المغرب يتكلّمون اللغات اللوبية، التي منها توالدت اللغات البربرية الحديثة
المتداولة راهنا في الجزائر، وفي المغرب الأقصى.
الذي تميزت به البلاد التونسية في العهد الروماني. وقبل قدوم الرومان كان أهل
المغرب يتكلّمون اللغات اللوبية، التي منها توالدت اللغات البربرية الحديثة
المتداولة راهنا في الجزائر، وفي المغرب الأقصى.
ومع قدوم الرومان وانتشارهم في أماكن مختلفة، وبعثهم للمدارس والجامعات، شهدت
اللغة اللاتينية انتشارا واسعا، جاذبة إليها النخب الجديدة من أهل البلاد
الأصليين. وكان الرومان يولون البلاغة وفنّ الخطابة الذي برع فيه الكثير من أبناء
روما، اهتماما كبيرا. وفي المرحلة الأخيرة من التعليم يقع التركيز على تلقين
الطلبة الفصاحة وعلم البيان استنادا إلى النصوص الأدبيّة الرفيعة.
اللغة اللاتينية انتشارا واسعا، جاذبة إليها النخب الجديدة من أهل البلاد
الأصليين. وكان الرومان يولون البلاغة وفنّ الخطابة الذي برع فيه الكثير من أبناء
روما، اهتماما كبيرا. وفي المرحلة الأخيرة من التعليم يقع التركيز على تلقين
الطلبة الفصاحة وعلم البيان استنادا إلى النصوص الأدبيّة الرفيعة.
كما أن الطلبة كانوا يقبلون على مشاهدة
مسرحيّات تقدم باللغة اليونانية التي ظلت في العهد الروماني، خصوصا في المنطقة
الشرقية، لغة النخب الفلسفية والفكرية، ولغة كبار الأدباء والشعراء. وكان الطلبة
يستمعون أيضا إلى محاضرات في الفلسفة، ويشاركون في المناظرات الشعرية. ولم تكن
الدراسة تشغلهم، كما أثبت ذلك القديس أوغسطينوس في “اعترافاته”، عن اللهو والعبث
والمجون وحضور حفلات خليعة في المسرح، وأخرى دموية وعنيفة في المُدرّج البيضوي.
مسرحيّات تقدم باللغة اليونانية التي ظلت في العهد الروماني، خصوصا في المنطقة
الشرقية، لغة النخب الفلسفية والفكرية، ولغة كبار الأدباء والشعراء. وكان الطلبة
يستمعون أيضا إلى محاضرات في الفلسفة، ويشاركون في المناظرات الشعرية. ولم تكن
الدراسة تشغلهم، كما أثبت ذلك القديس أوغسطينوس في “اعترافاته”، عن اللهو والعبث
والمجون وحضور حفلات خليعة في المسرح، وأخرى دموية وعنيفة في المُدرّج البيضوي.
وكان مرقُوس قُرنليوس أفرنتو أول من اشتهر من أبناء أفريقية (تونس الآن) في
مجال الفصاحة وفن الخطابة، وهو من مواليد بقيرطا (قسنطينة راهنا). وبعد أن أكمل
دارسته أمضى بضع سنوات في الإسكندرية التي كانت آنذاك مركزا مهما للثقافة
اليونانية. بعدها انتقل إلى روما، وفيها اشتهر بـ”سعة ثقافته، وفصاحة لسانه،
وتفوّقه في المحاماة”.
مجال الفصاحة وفن الخطابة، وهو من مواليد بقيرطا (قسنطينة راهنا). وبعد أن أكمل
دارسته أمضى بضع سنوات في الإسكندرية التي كانت آنذاك مركزا مهما للثقافة
اليونانية. بعدها انتقل إلى روما، وفيها اشتهر بـ”سعة ثقافته، وفصاحة لسانه،
وتفوّقه في المحاماة”.
وقد ازدادت شهرته اتساعا بعد أن عيّن
معلّما للشاب مرقوس أورليوس قبل أن يعتلي العرش الإمبراطوري.عنه كتب عمّار
المحجوبي يقول “وممّا ميّز أفرنتو، أسلوبه السهل في رسائله، وتعبيره البليغ، لكنه
كان كثير التعلق بجمال الأسلوب إلى حدّ التكلّف، وبندرة اللفظ واختياره من بين
قديم الكلام إلى حدّ التعقيد، وكثير الإهمال للمعنى وجوهر الخطاب حتى صار يطرق
مواضيع تافهة المعنى، ساذجة اللبّ، كالإشادة بالدخان، والتنويه بمزايا الغبار”.
معلّما للشاب مرقوس أورليوس قبل أن يعتلي العرش الإمبراطوري.عنه كتب عمّار
المحجوبي يقول “وممّا ميّز أفرنتو، أسلوبه السهل في رسائله، وتعبيره البليغ، لكنه
كان كثير التعلق بجمال الأسلوب إلى حدّ التكلّف، وبندرة اللفظ واختياره من بين
قديم الكلام إلى حدّ التعقيد، وكثير الإهمال للمعنى وجوهر الخطاب حتى صار يطرق
مواضيع تافهة المعنى، ساذجة اللبّ، كالإشادة بالدخان، والتنويه بمزايا الغبار”.
وما زال أبوليوس الذي عاش في منتصف القرن
الثاني يحظى بشهرة عالمية واسعة بفضل رائعته “تحولات الجحش الذهبي” التي نالت
إعجاب كبار الأدباء والشعراء في جميع الثقافات واللغات القديمة والحديثة. ويجمع
المؤرخون على أنه كان أحد كبار المجددين في الآداب اللاتينية.
الثاني يحظى بشهرة عالمية واسعة بفضل رائعته “تحولات الجحش الذهبي” التي نالت
إعجاب كبار الأدباء والشعراء في جميع الثقافات واللغات القديمة والحديثة. ويجمع
المؤرخون على أنه كان أحد كبار المجددين في الآداب اللاتينية.
وكان مواكبا أيضا للنهضة التي شهدتها اللغة اليونانية في العهد الروماني.
ومبكرا ترك أبوليوس مسقط رأسه بمودوروس(هي الآن على الحدود التونسية-الجزائرية)،
ليتابع دراسته في قرطاج مُنجذبا إلى الأفلاطونية الجديدة، وإلى الأديان الشرقية،
كما إلى السحر وعالم الغيب. ويروي المؤرخون أنه لجأ إلى السحر لإغراء امرأة غنية
تزوّجها بعد عودته من أثينا.
ومبكرا ترك أبوليوس مسقط رأسه بمودوروس(هي الآن على الحدود التونسية-الجزائرية)،
ليتابع دراسته في قرطاج مُنجذبا إلى الأفلاطونية الجديدة، وإلى الأديان الشرقية،
كما إلى السحر وعالم الغيب. ويروي المؤرخون أنه لجأ إلى السحر لإغراء امرأة غنية
تزوّجها بعد عودته من أثينا.
تونس قطب ثقافي في ظل الإمبراطورية
في طرابلس التي كانت تسمى آنذاك “أويا”
تعرف على كبار العائلات فيها. وفي مدينة صبراطة، مَثَلَ أمام المحكمة وألقى مرافعة
شهيرة اختار لها عنوان “التبرير”.
تعرف على كبار العائلات فيها. وفي مدينة صبراطة، مَثَلَ أمام المحكمة وألقى مرافعة
شهيرة اختار لها عنوان “التبرير”.
وبعد أسفار ورحلات طويلة في مختلف مناطق
البحر المتوسط، استقر أبوليوس في قرطاج ليعيش السنوات الأخيرة من حياته مكللا
بالمجد والشهرة. وقد تضمنت روايته “تحولات الجحش الذهبي” التي ألفها سنة 170
ميلاديًّا، والتي كانت باكورة الروايات النثرية اللاتينية، مشاهد مضحكة وأخرى
مأساوية عن الحياة الاجتماعية في البلاد التونسية زمن الرومان. بطل الرواية شخص
يدعى لوقيوس يناله الدنس فيتحوّل إلى جحش شكلا وخلقا. وفي النهاية يتخلص من اللعنة
التي أصابته بعد أن ابتهل إلى الربة الشرقية إيزيس.
البحر المتوسط، استقر أبوليوس في قرطاج ليعيش السنوات الأخيرة من حياته مكللا
بالمجد والشهرة. وقد تضمنت روايته “تحولات الجحش الذهبي” التي ألفها سنة 170
ميلاديًّا، والتي كانت باكورة الروايات النثرية اللاتينية، مشاهد مضحكة وأخرى
مأساوية عن الحياة الاجتماعية في البلاد التونسية زمن الرومان. بطل الرواية شخص
يدعى لوقيوس يناله الدنس فيتحوّل إلى جحش شكلا وخلقا. وفي النهاية يتخلص من اللعنة
التي أصابته بعد أن ابتهل إلى الربة الشرقية إيزيس.
ومع انتشار المسيحية في كامل مناطق
أفريقية، برز أدباء ومفكرون كبار، ولعل القديس أوغسطينوس (334-430) أعظم هؤلاء
جميعا. ويشير عمّار المحجوبي إلى أن مكانته لا تختلف عن مكانة ابن خلدون في القرن
الرابع عشر بعد أن ساد الإسلام، وانتشرت اللغة العربية. وهو من مواليد بتغاست في
موقع سوق هراس اليوم على الحدود الجزائرية-التونسية.
أفريقية، برز أدباء ومفكرون كبار، ولعل القديس أوغسطينوس (334-430) أعظم هؤلاء
جميعا. ويشير عمّار المحجوبي إلى أن مكانته لا تختلف عن مكانة ابن خلدون في القرن
الرابع عشر بعد أن ساد الإسلام، وانتشرت اللغة العربية. وهو من مواليد بتغاست في
موقع سوق هراس اليوم على الحدود الجزائرية-التونسية.
ومبكرا حفظ أوغسطينوس ملاحم
هوميروس وفرجيليوس، كما تعلم اليونانية واللاتينية. وفي قرطاج التي استقر فيها
شابا، درس الفلسفات اليونانية، مظهرا نفورا واضحا من المسيحية.
هوميروس وفرجيليوس، كما تعلم اليونانية واللاتينية. وفي قرطاج التي استقر فيها
شابا، درس الفلسفات اليونانية، مظهرا نفورا واضحا من المسيحية.
وفي مدينة ميلانو اختلط بالأوساط الأدبية
والفكرية والفلسفية، واقترب من النخب المتهافتة على البلاط الإمبراطوري. وتحت
تأثير أمبرزيوس، أسقف ميلانو، فتن بالمسيحية وعاد إلى بلاده ليصبح أسقف مدينة
هبّونا (عنابة الآن). وفي هذه الفترة من حياته، انشغل بتأليف “الاعترافات”،
و”مدينة الله”، و”البحث في مسألة الثالوث”.
والفكرية والفلسفية، واقترب من النخب المتهافتة على البلاط الإمبراطوري. وتحت
تأثير أمبرزيوس، أسقف ميلانو، فتن بالمسيحية وعاد إلى بلاده ليصبح أسقف مدينة
هبّونا (عنابة الآن). وفي هذه الفترة من حياته، انشغل بتأليف “الاعترافات”،
و”مدينة الله”، و”البحث في مسألة الثالوث”.
وفي عام 430 ميلاديّا زحف الوندال على
أفريقية ودمروا مدنها، وحاصروا هبونا، فأصيب أوغسطينوس بحمّى شديدة أدت إلى وفاته
في الثامن والعشرين من شهر أغسطس عام 430 ميلاديّا. وبوفاته فقد الغرب المسيحي
“مفكرا أضاء بنور عبقريته حضارة العهد القديم، وساهم في إشعاعها على العالم
بأسره”.
أفريقية ودمروا مدنها، وحاصروا هبونا، فأصيب أوغسطينوس بحمّى شديدة أدت إلى وفاته
في الثامن والعشرين من شهر أغسطس عام 430 ميلاديّا. وبوفاته فقد الغرب المسيحي
“مفكرا أضاء بنور عبقريته حضارة العهد القديم، وساهم في إشعاعها على العالم
بأسره”.